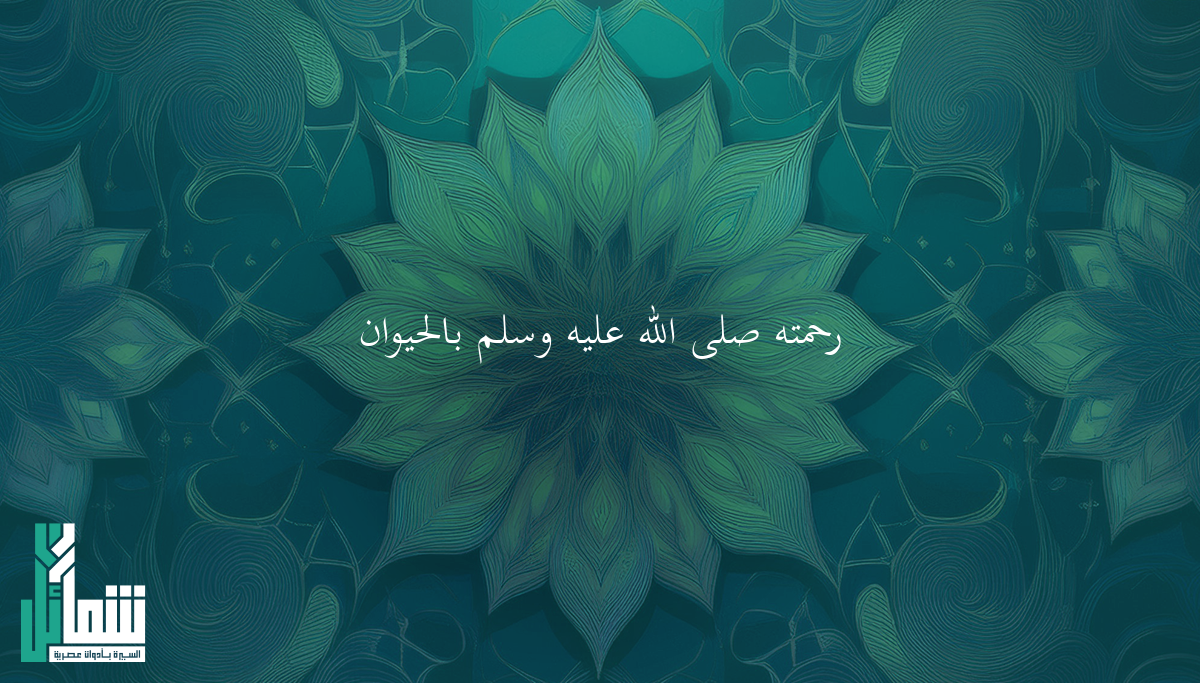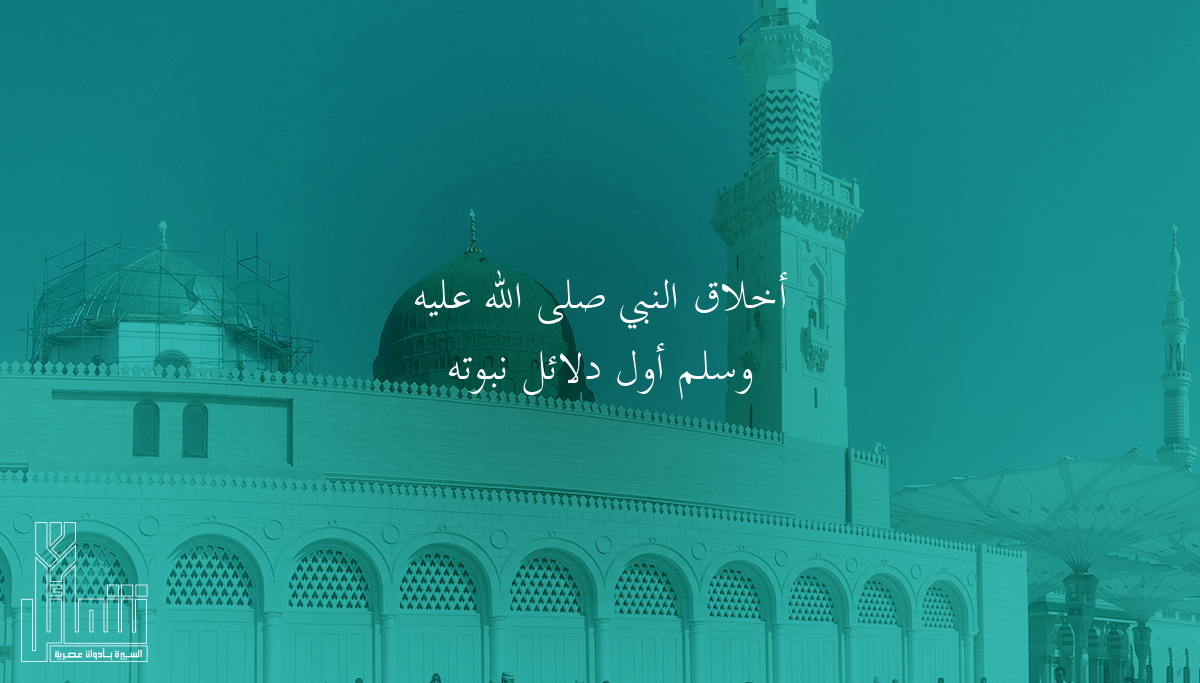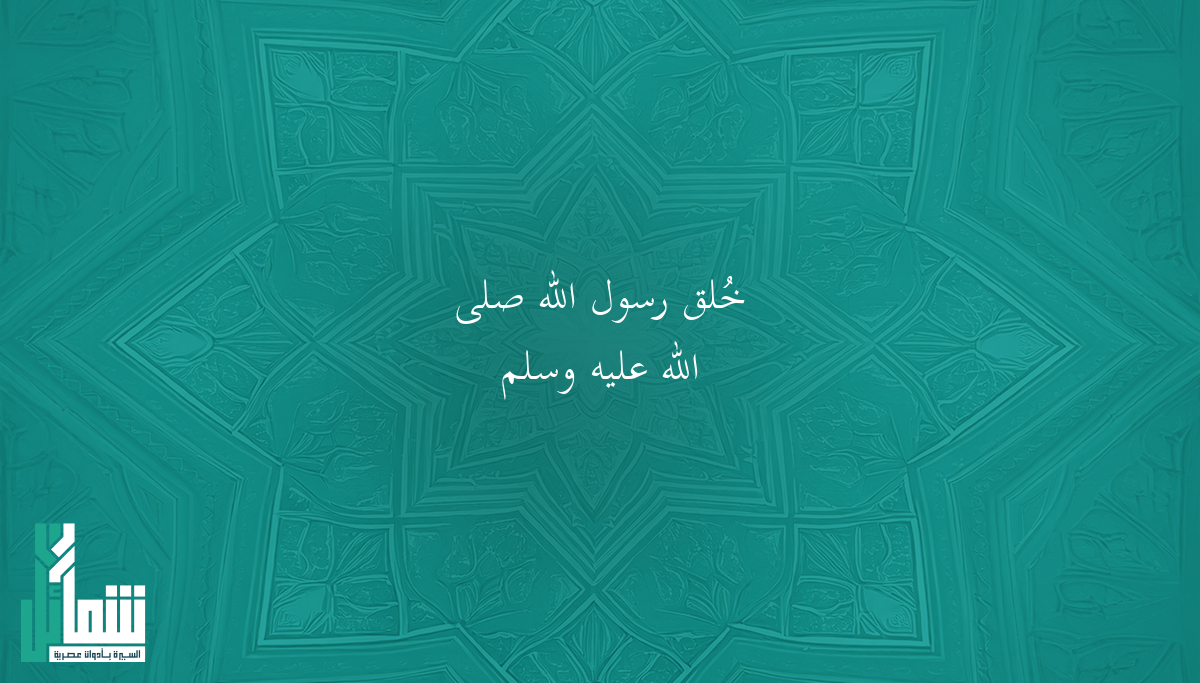كان النبيُّ ﷺ يدعو إلى حُسن الخُلق، ويرسِّخ في نفوس أصحابه والمؤمنين مكارم الأخلاق، وقد أخبر ﷺ أنه بُعث ليتمِّم مكارم الأخلاق؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه – قال : قال رسول الله ﷺ : «إنما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق»[1] .
البِرُّ حُسنُ الخُلُقِ:
سئل النبيُّ ﷺ عن البر فأجاب بجوابٍ بيِّنٍ شافٍ جامعٍ من جوامع كلامه ﷺ، فقال عن البِرِّ: «البِرُّ حُسنُ الخُلُقِ»، فبيَّن ﷺ أن البِرَّ هو حُسن الخُلق.
و"حُسن الخُلق أعظم خِصال البِرِّ، ويعني بحُسن الخُلق: الإنصافَ في المعامَلة، والرِّفق في المجادَلة، والعدل في الأحكام، والبذل، والإحسان"( [2])، أو أن حُسن الخلُق يشمَل كلَّ خصال الخير والطاعة؛ فـ"البِرُّ يكون بمعنى الصلة، وبمعنى اللُّطف، والْمَبَرَّة، وحُسن الصُّحبة والعِشرة، وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامعُ حُسن الخلُق"([3] ).
المراد بحُسن الخُلق:
"قيل: إن حُسن الخُلق بذلُ النَّدى، وكفُّ الأذى، واحتمال الأذى. وقيل: حُسن الخُلق: بذل الجميل، وكفُّ القبيح، وقيل: التخلِّي من الرذائل، والتحلِّي بالفضائل"( [4]).
وقيل: المراد بحُسن الخُلق: "أي: حُسن الخُلق مع الله، وحُسن الخُلق مع عباد الله، فأما حُسن الخُلق مع الله، فأن تتلقَّى أحكامَه الشرعيةَ بالرضا والتسليم، وألَّا يكون في نفْسك حرجٌ منها، ولا تَضِيقَ بها ذَرْعًا، فإذا أمرك الله بالصلاة، والزكاة، والصيام وغيرها، فإنكَ تُقابل هذا بصَدر مُنشرِح. وأيضًا حُسن الخُلق مع الله في أحكامه القدَرية؛ فالإنسان ليس دائمًا مسرورًا حيث يأتيه ما يُحْزنه في ماله، أو في أهله، أو في نفْسه، أو في مجتمَعه، والذي قدَّر ذلك هو اللهُ عزَّ وجلَّ، فتكون حَسنَ الخُلق مع الله، وتقوم بما أُمِرْتَ به، وتَنزجر عمَّا نُهِيتَ عنه. أما حُسن الخُلق مع الناس، فهو: بَذْل النَّدى، وكفُّ الأذى، والصبر على الأذى، وطَلاقة الوجه"([5] ).
قال ابن القيم $: "وحُسن الخُلق يقوم على أربعة أركان، لا يُتصوَّر قيام ساقه إلا عليها: الصبرِ والعفَّة والشجاعة والعدل؛ فالصبر: يَحمِله على الاحتمال، وكَظْمِ الغَيظ، وكفِّ الأذى، والحلم والأناة والرفق، وعدم الطَّيش والعَجَلة. والعفَّة: تَحمِله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتَحمِله على الحياء، وهو رأس كلِّ خير، وتمنعه من الفحشاء والبُخل والكَذب والغِيبة والنميمة. والشجاعة: تَحمِله على عزَّة النفس، وإيثار معالي الأخلاق والشِّيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعةُ النفس وقوَّتها على إخراج المحبوب ومفارقته، وتَحمِله على كظم الغيظ والحِلم؛ فإنه بقوَّة نفسه وشجاعتها يُمْسِكُ عِنَانَهَا، وَيَكْبَحُهَا بِلِجَامِهَا عَنِ النَّزْغِ وَالْبَطْش؛ كما قال النبيُّ : «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ»، وهو حقيقة الشجاعة، وهي مَلَكة يقتدر بها العبد على قهر خَصمه. والعدل: يَحمِله على اعتدال أخلاقه وتوسُّطه فيها بين طرفَيِ الإفراط والتفريط، فيَحمِله على خُلق الجود والسخاء الذي هو توسُّط بين الذُّلِّ والقِحَة، وعلى خُلق الشجاعة الذي هو توسُّط بين الجُبن والتهوُّر، وعلى خُلق الحِلم الذي هو توسُّط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس، ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة"( [6]).
دعوة النبي ﷺ إلى حسن الخلق:
قال رسول الله ﷺ: «أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلْقُهُ»([7] ). فجَعَل البيت العُلويَّ جزاءً لأعلى المقامات الثلاثة، وهي حُسن الخُلق، والأوسط لأوسطها، وهو ترك الكَذِب، والأدنى لأدناها، وهو ترك الْمُمَاراة وإن كان معه حقٌّ. ولا رَيْبَ أن حُسن الخُلق مشتمِلٌ على هذا كلِّه.
وقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا، وَإِنَّ من أَبْغَضكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْنَا "الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ" فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالَ: «الْمُتَكَبِّرُون» ([8] ). (الثَّرْثَار): هو كثير الكلام بغير فائدة دينية، و(المتشدِّق): المتكلِّم بمِلءِ فِيهِ تفاصحًا وتعاظمًا وتطاولاً وإظهارًا لفضله على غيره، وأصله من الفَهْقِ وهو الامتلاء( [9]).
وقال رسول الله ﷺ: «خيارُكم أحاسنُكم أخلاقًا»( [10]).
وقال رسول الله ﷺ: «ما من شيءٍ أثقلُ في ميزان المؤمن يوم القيامة من حُسن الخُلق، وإن الله تعالى ليُبغِضُ الفاحشَ البذيء»( [11]).
وسُئل رسولُ الله ﷺ عن أكثرِ ما يُدخل الناسَ الجنَّةَ، فقال: «تقوى الله وحُسن الخُلق»، وسُئل عن أكثرِ ما يُدخل الناس النار، فقال: «الفَمُ والفَرْجُ»([12] ). جمع النبيُّ ﷺ بَين تقوى الله وحُسن الخُلق؛ لِأَن تقوى الله تُصلح مَا بَين العَبْد وَبَين ربِّه، وَحُسن الخُلق يُصلح مَا بَينه وَبَين خَلقه، فتقوى الله توجب لَهُ محبَّة الله، وَحُسن الْخلق يَدْعُو إِلَى محبَّته([13] ).
وقال النبيُّ ﷺ: «إن من أكمل المؤمنين إيمانًا: أحسنَهم خُلقًا، وخيارُكم خيارُكم لنسائهم»( [14]).
وقال رسول الله ﷺ: «إن المؤمن لَيُدْرِكُ بحُسن خُلقه درجةَ الصائم القائم»( [15]).
الدين كله حُسن الخُلق:
عن النَّوَّاس بن سَمْعانَ قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ عن البِرِّ والإثمِ، فَقالَ: «البِرُّ حُسْنُ الخُلُقِ، والإِثْمُ ما حاكَ في صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عليه النَّاسُ»([16] ).
قال ابن القيم $: "فقابَلَ البِرَّ بالإثم، وأخبر أن البرَّ حُسْنُ الخُلق، والإثمَ: حَوازُّ الصدور، وهذا يدلُّ على أن حُسن الخُلق: هو الدين كلُّه، وهو حقائق الإيمان، وشرائع الإسلام؛ ولهذا قابَله بالإثم. وفي حديث آخر: «البرُّ ما اطمأنَّت إليه النفس، والإثمُ ما حاك في الصدر»( [17])، وقد فسَّر حُسن الخُلق بأنه البرُّ، فدلَّ على أن حُسن الخلق: طمأنينةُ النفس والقلب، والإثم حَوَازُّ الصدور وما حاك فيها واسترابت به، وهذا غيرُ حُسن الخُلق وسوئه في عُرف كثير من الناس كما سيأتي في الصحيحين عن رسول الله ﷺ: «خيارُكم أحاسنُكم أخلاقًا»([18] )، وفي الترمذيِّ عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبيِّ ﷺ: «ما من شيءٍ أثقلُ في ميزان المؤمن يوم القيامة من حُسن الخُلق، وإن الله تعالى ليُبغِضُ الفاحشَ البذيء»([19] ) قال الترمذيُّ: حديث حسن صحيح. وفيه أيضًا وصحَّحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ سُئل عن أكثرِ ما يُدخل الناسَ الجنَّةَ، فقال: «تقوى الله وحُسن الخُلق» وسُئل عن أكثرِ ما يُدخل الناس النار، فقال: «الفَمُ والفَرْجُ»( [20]) وفيه أيضًا عن عائشة رضي الله عنها عن النبيِّ ﷺ وصحَّحه: «إن من أكمل المؤمنين إيمانا: أحسنَهم خُلقًا، وخيارُكم خيارُكم لنسائهم»( [21])
قال القرطبيُّ $: "إن حُسن الخُلق أعظم خِصال البِرِّ، ويعني بحُسن الخُلق: الإنصافَ في المعامَلة، والرِّفق في المجادَلة، والعدل في الأحكام، والبذل، والإحسان"([22] ).
قال النوويُّ $: "البِرُّ يكون بمعنى الصلة، وبمعنى اللُّطف، والْمَبَرَّة، وحُسن الصحبة والعِشرة، وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامعُ حُسن الخلُق"([23] ).
[1] رَوَاهُ أَحْمد وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِم وَصَحَّحهُ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة ، وقال ابن عبد البرِّ : هو متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره مرفوعًا.
[2] "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" للقرطبيِّ (6/ 523).
[3] "شرح النوويِّ على مسلم" (16/ 111).
[4] "مدارج السالكين" لابن القيم (2/ 307).
[5] "شرح الأربعين النووية" لابن عُثيمين (ص: 268).
[6] "مدارج السالكين" لابن القيم (2/ 308).
[7] رواه أبو داود (4800)، والطبرانيُّ في "المعجم الكبير" (7488)، وحسَّنه الألبانيُّ في "صحيح الترغيب والترهيب" (2648).
[8] رواه الترمذيُّ (2018)، وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح الترغيب والترهيب" (2897).
[9] "مدارج السالكين" لابن القيم (2/ 306، 307).
[10] رواه البخاريُّ (6035)، ومسلم (68).
[11] رواه الترمذيُّ (2002)، وقال: حديث حسن صحيح، وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح الترغيب والترهيب" (2641).
[12] رواه الترمذيُّ (2004)، وحسَّنه الألبانيُّ في "صحيح الترغيب والترهيب" (1723).
[13] الفوائد لابن القيم (ص: 54).
[14] رواه الترمذيُّ (1162)، وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح الترغيب والترهيب" (1923).
[15] رواه أبو داود (4798) وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح وضعيف سنن أبي داود" (4798).
[16] رواه مسلم (2553).
[17] رواه أحمد (18006)، وحسَّنه الألبانيُّ في "صحيح الترغيب والترهيب" (1734)
[18] رواه البخاريُّ (6035)، ومسلم (68).
[19] رواه الترمذيُّ (2002)، وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح الترغيب والترهيب" (2641).
[20] رواه الترمذيُّ (2004)، وحسَّنه الألبانيُّ في "صحيح الترغيب والترهيب" (1723).
[21] رواه الترمذيُّ (1162)، وصحَّحه الألبانيُّ في "صحيح الترغيب والترهيب" (1923).
[22] "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" للقرطبيِّ (6/ 523).
[23] شرح النوويِّ على مسلم (16/ 111).